أسماء المصري*
لم أكن أؤمن بذلك القفص البلاستيكي الذي تروِّج له بعض صديقاتي في الخفاء أثناء جلساتنا في العصرية.. أو ذلك القيد الذهبي الذي ألمحه يومض في عينيّ أمي الشاردتين بي، وهي توشوش قريبتنا.. أو حتى بـ “الموت فوق دفاتر أشعار” أحدهم.. كل ما آمنت به يومها كان عبثًا بالنسبة لكل هؤلاء..!
غابت الوشوشة لتصدح الزغاريد من حولي فجأةً.. وجدتني في تلك الشقة الكبيرة، حديثة الطراز، عصرية التفاصيل والأثاث، أتقاسمها مع شخص بالكاد عرفت اسمه منذ أيام.. لم يفارقني الذهول للحظة، خصوصاً لما تركتني أمي بعدما قبضتْ على يديّ بقوة، وأمْلتْ عليّ وصاياها، وودعتني بزغرودة صاخبة.
مدهونة جدرانها بالوحشة، وبين أركانها يقبع خوف أزلي، كل شيء بارد في هذه الشقة، وما هي إلا أيام حتى اكتشفت أنها أضيق مما كنت أظن.
ربما.. ممكن.. قد أكون مخطئة!.. وكلمات إسعافية أخرى كنت أُضمّد بها جراحي التي تغور مع الوقت.. كنت أُسَكّن بها ألم الساعات الطويلة التي أقضيها في تلك الشقة الواسعة بمفردي.
الأيام تستنسخ بعضها.. سرعان ما تلاشت الفرحة، واضمحلت أسباب المتعة، جَزْر السعادة على حاله، والأفق لا يبشر بشيء..
الحديث المختصر بيننا يزداد اختصاراً.. حتى أني ظننت لوهلة أنه سيأتي اليوم الذي سنكاتب فيه بعضنا داخل البيت، لفرط ما افترست الرتابة تفاصيل حياتنا.
في الوقت الذي كان الجميع بانتظار خبر أزفه إليهم في أية لحظة، تولـَّد بيننا إحساس مشوّه تجاه الآخر، وامتدت الكآبة بعرض اللحظات القليلة التي تجمعنا.
أُقلِّبُ الزهرية البيضاء، هدية أمي يوم زفافي، أتفرَّسُ ذلك الشرخ الطفيف في المنتصف، أدعكها بألم مزيلة عنها ما تراكم من اللا شيء.. كل يوم أدعكها بشدة، ثم أعيدها إلى مكانها مُردِّدة عبارة أمي المقتضبة كلما هاتفتها طالبة المساعدة “كوني مطيعة!”.. لم أدرِ أني أضاعف من شرخها إلا حين انفجرت بين يديّ فتطايرت الدماء وسالت على الجدار.. وعلمت أنني الآن وحدي، عليّ فعل شيء، أو بالأحرى عليّ فعل كل شيء..!
أعلنتُ حملة شاملة للتغيير، فما عاد شيء في مكانه: أعدتُ تنسيق الأثاث، استبدلتُ الستائر وألوان الأغطية، عدَّلتُ مواضع التحف والأجهزة، أضفتُ بعض الزينة، وضعتُ زهرية أخرى أكبر حجمًا عوضًا عن المكسورة، ملأتُ جوفها بالورد الأحمر النضر، أبادلهُن كل يوم بأخريات دون أن يلاحظ.. كان يمر بكل هذه الثورات المنزلية بهدوء، سائلاً تارة عن غدائه، ثيابه النظيفة، أغراضه التي يلقيها كل ليلة في غير أماكنها حين عودته متأخرًا، ثم ينكفئ على هاتفه المحمول لساعات بعيداً عن محيط أذنيّ، وهي اللحظات الوحيدة التي ألمحه فيها منفعلاً أو مسرورًا.
اشتريتُ ملابس جديدة وارتديتها، قصصتُ شعري، لوَّنتُ خصلاته، أطلتُ رموش عيني، طليتُ أظافري، جدَّدتُ بشرتي، نقشتُ جسدي، رششتُ العبير، سلَّمتُ أذنيّ لبرامج الجمال، المطبخ، الديكور، الأسرة، الصحة، الطب النفسي، الشعوذة، حتى ضبطتُ نفسي مرات عديدة أتحدث إليها في المرآة.
الحجرة مظلمة، التحفتُ بسهدٍ ثقيل.. الدقائق تقتات صبري.. غدوت جزءًا من تلك القطع الساكنة التي تمتلئ بها الأركان.. وحدها الستائر الشفافة من أبت السكون، تستمتع بمراقصة نسيم ليلي بارد.. أرمقهما بنظرة إنكار، لا يباليان، أنتفض، أشدّ الستارة بعنف، وأصفع النافذة واضعةً حدًّا لهذه المهزلة.. أعود إلى مكاني بين أحضان الخوف، وأتابع طقوسي بأعلى درجات الصمت.
تتالت الأيام، خَلت المحاولات من الأمل، تضاءل اهتمامي، ذبلت الورود دون أن أشعر, وعندما شعرت، لم أستبدلها.. كنت مشغولة وقتها بالتفكير في أني أعايش شبحًا.
قالت لي جارتي، فيما بعد:
“عندما عاد تلك الليلة ولم يجدكِ، ظل يجوب حجرات الشقة كالمعتوه.. يُقلِّب كل شيء في عصبية.. يركل كل ما يعترض طريقه بهستيرية.. يُفتــِّــش ويُفتــِّــش.. لم يستطع أحد إيقافه.. لم ينجح أيٌّ في تهدئته.. ثم تركوه يهوي على ركبتيه.. يصرخ.. ويصرخ.. يعوي طوال الليل: أين العشاء؟!”.
*قاصة يمنية حائزة على جائزة الدولة للشباب عام 2010، وصدرت لها أربع مجموعات قصصية هي: “يحكى أن سيكون، أجراس العودة، مجرور بالحسرة، تقاصي”.









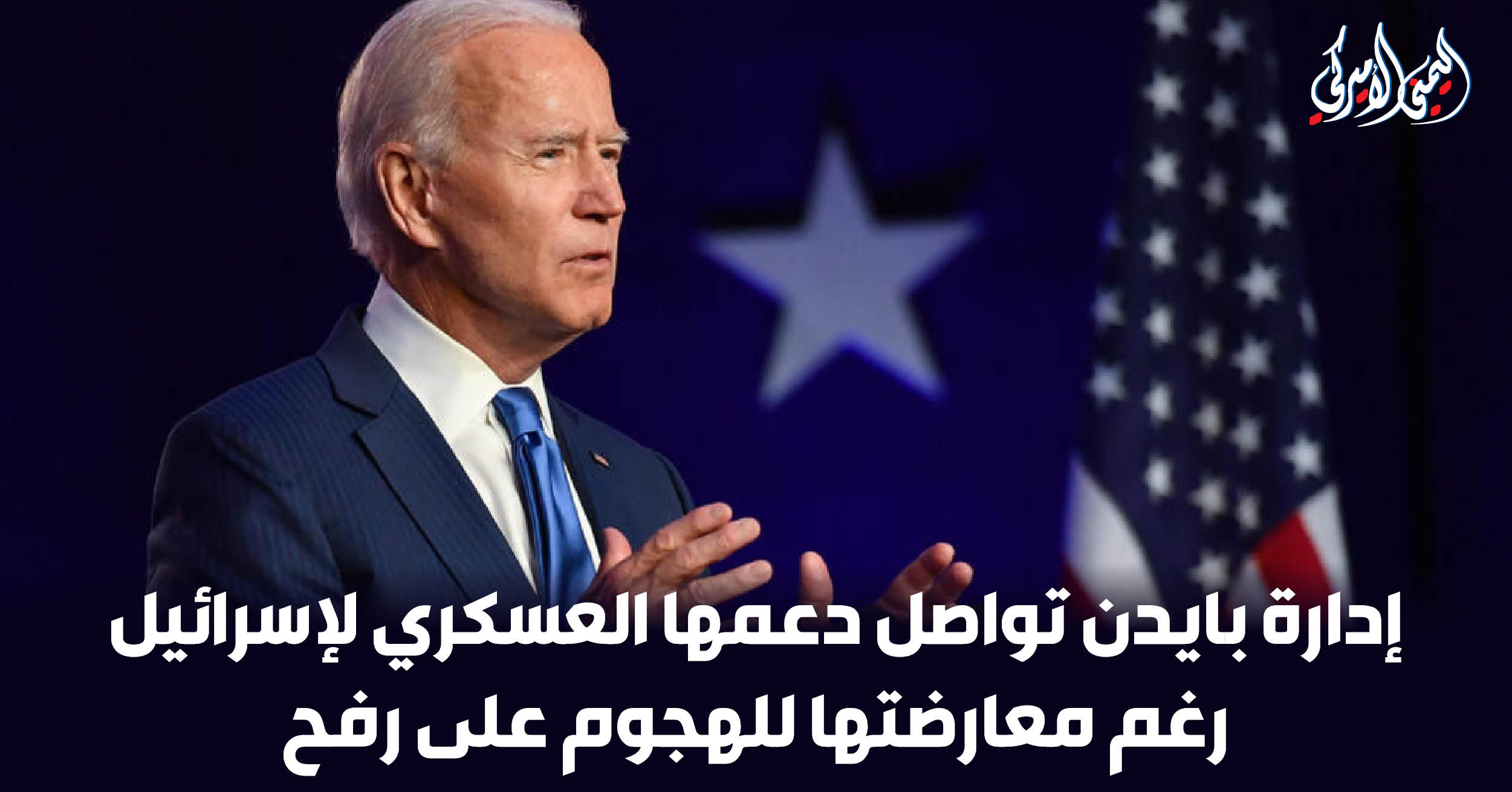
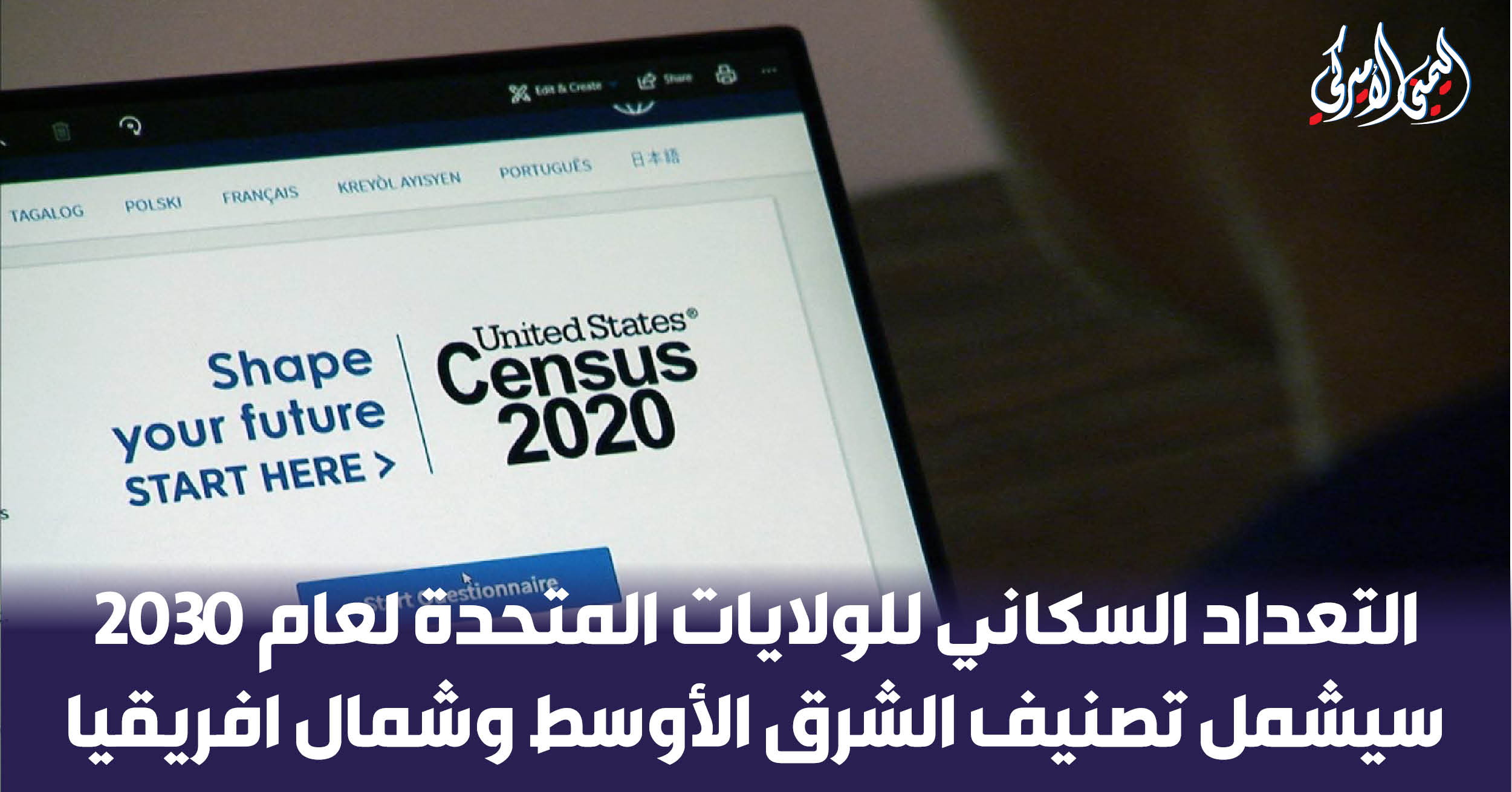

تعليقات