إبراهيم موسى النحَّاس*
إذا كان الأدب لا ينفصل تمامًا عن المجتمع، وإذا كانت “جوليا كريستيفا” في كتابها الرائع (ثورة اللغة الشعرية) نظرت إلى الكتابة – بوجه عام – باعتبارها عمليات اجتماعية ونقدية اجتماعية، فإنَّ الروائي علوان مهدي الجيلاني في روايته الجديدة (مِعْلَامة) يتعامل مع العمل الأدبي من منظور خاص، منظور يجمع بين محاور متنوعة تتجاوز رؤية مُنظِّري علم اجتماع الأدب، حيث نجد في روايته كيف يخلق الواقع الموازي الجميل في مواجهة قبح الواقع الآني، وكيف تكون النوستالجيا لذكريات فترةٍ ما كالطفولة مثلًا هي أحد أسلحة الذات التي تمنحها القوة في مواجهة سلبيات ذلك الواقع دون أن تكون هربًا منه، كما تتجاوز الرواية التعبير عن المُهمَّشين – كحالة اجتماعية – بل تقوم بتحويل الهامشي إلى متن يعلو أحيانًا فوق متون كبرى كثيرة.
تنتمي الرواية إلى فن السيرة الذاتية، التي تعيدنا إلى الجزء الأول من رواية (الأيام) لعميد الأدب العربي طه حسين، وإن اختلفت معها في التفاصيل والهدف، فالأيام عند طه حسين كانت لتوضيح مدى معاناته (الفقر وفقدان نعمة البصر) وإصراره على تحصيل العلم للالتحاق بالأزهر الشريف الذي تمرَّد على أسلوب الدراسة النقلية ليلتحق بعدها بجامعة فؤاد الأوَّل (جامعة القاهرة) ويصل إلى ما وصل إليه، بينما الوضع عند علوان مهدي الجيلاني مختلف حيث يجعل من السيرة الذاتية شعاع نور ونافذة جميلة يُطل بها على الحاضر والمستقبل، فالسيرة الذاتية نبعت عند طه حسين من حاضر جميل يستقي العبرة وتعليم الطموح للأجيال اللاحقة من ماضيه المعتم، بينما عند علوان العكس، نجد الماضي الجميل الذي يعطي جَمالًا لواقع معتم أحيانًا، بل يكون جمال هذا الماضي سلاحًا يواجه به قبح الواقع المُتردِّي على المستوى الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمجتمع.
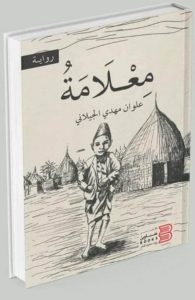
– المعلامة وتحويل الهامش إلى متن:
أ) على مستوى المكان:
يلعب المكان في الرواية دور البطل الحقيقي، ومن بين كل الأماكن في الرواية اختص الكاتب ثلاثة أماكن تكون بمثابة الأبطال المحوريين في الرواية، المكان الأوَّل هو المِعْلَامَة (أي الكُتَّاب)، وكُلُّنا نعرف دور الكتاتيب في دولنا العربية في كونها النواة والمُؤسَّسة الأولى لتعليم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واللغة العربية للأطفال، خصوصًا في البيئات الريفية دون تفرقة في المستوى الطبقي أو الاجتماعي لمرتاديها من التلاميذ. ورغم أهميتها، لكن يُنظر إليها الآن – من وجهة نظر الكثيرين – باعتبارها شيئًا هامشيًّا، بعد تلك الطفرة الهائلة في التوسع في بناء المدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات، لكن الكاتب يُحوِّلها من هامش إلى متن، لتكون محور الرواية، بل ويحمل عنوان الرواية اسمها، ويُبيِّن عظمتها وعظمة تأثيرها في نفسه وعظمة تأثير “سَيِّدنا” مُعلِّمهم في المعلامة وهو الشيخ “علي بلغيث الفروي”، فرغم بساطة بنائها تبقى عظمتها – هي وشيوخها – راسخة في النفوس فيقول: (كانت المعلامة عريشًا بناه جدِّي في حوش منزلته، وجاء بالفقيه علي أبي الغيث الفروي – من دير عطاء مقام شيخ شيوخ صوفية اليمن شمس الشموس أبو الغيث بن جميل رضي الله عنه – ليقوم بتحفيظنا القرآن وتعليمنا القراءة والكتابة والحساب ومبادىء الفقه. كُنَّا نناديه سيدنا. وكان رجلًا صالحًا نقيًّا مباركًا لم أرَ حتى اليوم أحدًا يتصف بصفاته).
المكان الثاني: (المنزلة): والمنزلة هي ما يُشبه ديوان العائلة في الريف المصري، مكان اجتماعاتهم وسمرهم وجلسات حل المشكلات والخلافات، ومكان تلقي العزاء، واستضافة الضيوف في الأعراس والمناسبات المختلفة، و”المنزلة” الآن شيء هامشي نتيجة التوسع في أعمال البناء والهجرات الخارجية والداخلية، والتفكك الاجتماعي بسبب طابع الحياة السريع والآثار السلبية للإنترنت، لكن تبقى للمنزلة مكانتها عند الكاتب، فينقلها من دائرة الهامشي إلى أحد المتون، بل يحتفي بمُرتاديها حتى وإن كانوا من المُهمَّشين في المجتمع، وها هو يؤكد هذا بقوله: (كانت منزلتنا مهوى لكثير من أهل الله، أكثرهم سلبت عقولهم المَحَبَّة، وأخذتهم جذبات العشق، وأنوار القرب من أحوال دنيانا كُلّها. يرتاح جدِّي لوجودهم، يعيشون حاضرين في الوجدان بسبب تجليات شخصياتهم، بركتهم، وغرائب ما يصدر منهم، أمَّا على المستوى الواقعي المادي فهُم يعيشون على هامش المنزلة، متكآتهم دائمًا في الركن القصي، ومشاركاتهم في الشأن العام الذي تشهد المنزلة وقائعه قليلة، أو تكاد تكون منعدمة).
المكان الثالث سبيل الماء: والبريح هو عملية تجميع الماء بالدلاء من سبيل المياه، وإذا كان سبيل الماء صار هامشيًّا بسبب التقدم في توصيل المرافق للبيوت والمباني السكنية، لكنه ارتبط في ذاكرة الكاتب بأحداث جعلته يصير متنًا، فقصص الحب كانت تبدأ عنده: (ارتبط البريح بأجمل السرديات، كثيرًا ما تبدأ قصص الحُب أثناء البَرِيح، ما أن تظهر ميول الشاب تجاه فتاة ما، حتى يُعبّر عن تلك الميول، ليس بالنظرة والابتسامة والكلمة، ولكن بالأفعال، طوال الوقت يتحين الفُرَص لمساعدتها أثناء البريح، يلقف لها الدلو، يصُب لها الماء في الكَدّ، يروي لها الدواب، يُحَمِّلُ لها الكُدّان على الحمار، وإن خرب دلوها أعطاها دلوه، أو اشتبك رشاؤها بأرشية غيرها سارع لفكّه. الناس يلحظون ذلك ولا يعترضون، فهو عاشق سوف يخطب؛ لتتواصل مهمة خدمة المحبوبة بشكل أوسع، ولا يخلو الأمر من جوائز، فهو سيخطف قبلة هُنا أو هناك، وسيدَّعي العطش لتسقيه من الدلو، سترفع هي الدلو وسيحوَّل هو كفَّيه إلى إناء شُرْب، لكنه وهي تنحني لتسقيه سيرى نهديها المضغوطين في الصديرية، وسيشم عرف الحناء والهرد والحسن وقد اختلط بعرقها….. لم يكُن البَرِيحُ مجرد عمل روتيني يقوم به الناس كُلّ يوم، كان رغم مشقته من أكثر المظاهر تعبيرًا عن العادات والتقاليد الاجتماعية المميزة لكُلِّ القرى والأديرة في تهامة. كانت كُلّ أخبار الناس وما يحدث بينهم، يتم تداولها أثناء البَرِيح).
ب) الشخصيات الروائية من الهامشي إلى المتن:
حفلت الرواية بالعديد من الشخصيات التي تعكس جانبًا مهمًّا في فكر الكاتب وأيديولوجيته، فرغم نشأة الكاتب في أسرة ثرية، لها مكانتها المرموقة كطبقة اجتماعية متميزة في بيئتها، لكنه بسبب طبيعة أحاسيسه المرهفة ينحاز دائمًا للطبقات المهَمَّشة في المجتمع، وقد انعكس هذا على طبيعة توظيفه للشخصية الروائية، فنجد الكثير من الشخصيات المهمشة اجتماعيًّا يتم نقلها من دائرة الهامش إلى دائرة المتن، مثل شخصية (يحيى المهدلي) أحد مرتادي “منزلة الجيلانية”، حيث أفرد الكاتب له وصفًا تفصيليًّا، بل جعله يسمو على شخصية ذات مكانة اجتماعية كبيرة حينما قال: (كان يحيى نحيفًا مُقوَّس الجسد بشدة، لونه قمحيٌّ مغْبَرٌّ، وملابسه رثّة (تجابير) لكنها نظيفة، تبدو عليه سيماء المجاذيب، وكنا نستغرب لبقائه على قيد الحياة، فهو لا يكاد يأكل، قد يتصرف تصرفًا أو يقول كلامًا صادمًا، تحسبه للوهلة الأولى غير منطقي، فيه قلة ذوق، أو عدم قدرة على التقدير، لكنك حين تتفكر فيه، فإن مغزاه يكون عميقًا جدًّا. ذات مرة كان يجلس وحيدًا في المنزلة، حين دخل واحد من الوجهاء المشهورين. قال القادم بصوت عال: السلااااام عليكم. فرَدَّ يحيى بصوت خفيض مليء بالازدراء: وعليكم ما في أقدامكم. صعق الرجل، لكنه ما لبث أن ابتسم متقبلًا بعد أن فهم الرسالة، فهو كان يمر بحال من العنجهية والغرور ذلك اليوم، وكان يجب أن يجد يحيى ليُعلمه التواضع والصبر والمحبة).
أيضًا من الشخصيات الهامشية التي احتفت بها الرواية، أعضاء فرقة (بنات امريمي) وهي فرقة شعبية كانت تجول البلاد والقرى لإحياء المناسبات المختلفة، وقد اختصَّت الرواية شخصية بطلة الفرقة الراقصة “أمعيدة” بالوصف، للتعبير عن المتغيرات الحياتية والاجتماعية بعد أزمة حرب الخليج، فيقول الكاتب: (كانت «أمعيدة» امرأة خضراء “أي سمراء البشرة” في حدود الخمسين، ما تزال آثار جمالها السابق تتلو شواهدها في تقاطيع وجهها المتناسقة، وحركة جسدها الرشيق إلى حَدٍّ كبير، نسبة إلى عُمرها، ومعاناتها نتيجة التشرُّد بعد الأزمة، وكانت الحسرات تملأ عيون كُلّ مَن عرفوها أيام زمان، خاصة وأنَّها قد نُكبت بين مَن نُكبوا، وفقدت حياة الرفاهية التي كانت تعيشها، ثم عادت لتجوب القُرى كما كانت تفعل في سنوات الخمسينيات والستينيات، بعد أن تبدَّل كُلُّ شيء، فلا هي مثلما كانت زمان، ولا الزمان والمفاهيم كما كانت، ويبدو أنَّ «أمعيدة» كانت تشعر بالفارق الهائل، والمتغيرات التي حدثت فيها وفي الناس وفي الحياة كُلّها. فلم يكُن الحزن يفارق وجهها أو صوتها، وكأن لسان حالها يترجم قول ابن هتيمل الضمدي:
لا الزمانُ الزمانُ فيما عهدناه / قديمًا ولا الديارُ الديارُ
بعد عام من ذلك اليوم، حضرت «أمعيدة» عُرْسًا في محل عابد، ثم غادرت المحل ليلًا، متجهة إلى قريتها دوغان عبر مسيل وادي تباب، وإلى الجنوب من الجيلانية باغتها الموت – رُبَّما إثر أزمة قلبية – سقطت عن حمارها وحيدة غريبة، وقد صعدت روحها إلى بارئها).
الواقع السياسي بين السطور:
من السمات الجميلة للأدب أن يُلمِّح أكثر مِمَّا يُصرِّح، وهذا ما نلمسه في رواية (معلامة) علوان مهدي الجيلاني، فلم تتعرَّض الرواية للأزمات السياسية بشكل مباشر يقوم على التقريرية والتصريح، وإنَّما كان توظيف الرمز وقراءة ما بين السطور هُما وسيلة الكاتب للتعبير عن رؤيته، ظهر هذا من خلال توظيف شخصية الجدَّة، ففي مشهد كوميدي لهذا الطفل الذي يخشى عقاب والده لهروبه يومًا من درس “المعلامة” نجد أن جدّة الطفل تقوم بتخبئته عن عين أبيه عن طريق وضع (بردعة) الحمار فوقه، رغم ما في هذا المشهد من بساطة تتناغم مع براءة وبساطة الطفولة، لكنه يحمل إسقاطات سياسية وفلسفية، فإذا كانت الجدَّة هي مصدر الحماية لعلوان الصغير من الخوف الذي أصابه أمس، فأين تكون الحماية من الخوف الذي يصيبه ويصيب غيره من اليمنيين اليوم؟، وإذا كان الترابط الاجتماعي سمة بارزة في الجيلانية : الجد والجدّة والأب والأم والأعمام والأخوال وبقية الأهل، فهل هذا الترابط الاجتماعي بمثابة (المعادل الموضوعي) – بلغة توماس إليوت – أو الرمز لدعوة المجتمع إلى نبذ التفكك والاقتتال الداخلي والاتجاه نحو الوحدة والترابط؟ الرواية هنا تطرح الأسئلة بين سطورها بعيدًا عن التقريرية ولغة التصريح المباشر واللهجة الخطابية، وهذا من السمات الفنية الجميلة فيها.
جانب سياسي اجتماعي تنويري آخر، وهو تعظيم الرواية لقيمة ودور المرأة في الحياة، ويكفي هذا الوصف الدقيق لشخصية جدَّته لتأكيد هذا الملمح حين يقول: (كنت صغيرًا ومولعًا بخالي، لكنَّني كنتُ مولعًا بجدَّتي أكثر، كانت نموذجًا فريدًا بين النساء، جميلة ونظيفة، لا يتوقف اهتمامها بالنظافة على جسدها وألفاظها وملبسها، بل يتعدَّاه إلى كُلِّ زوايا البيت والمطبخ، وأدوات الحياة كافة، كان حرصها على النظافة يجعل كُلّ نساء الجيلانية يخشين ملاحظاتها. وفوق ذلك كانت امرأة حازمة شجاعة ونافذة الكلمة، لا يعجبها الغلط أو الحال المائل.. مع كونها أكثر من نهر حنان دافق). مثل هذا الوصف يُعلي من شأن المرأة، ويتجاوز النظرة إليها بالفكر الذكوري العقيم، ذلك الفكر الذي يهضم حقوقها ويتجاهل قيمتها الفكرية والثقافية والاجتماعية، ليختزل كل هذا في النظرة للمرأة باعتبارها جسدًا وعورة، يجب حجبها وإلغاء أي دور آخر لها. من هُنا تحمل الرواية ذلك البعد التنويري على المستويين السياسي والاجتماعي معًا.
كما حملت الرواية بعض الإسقاطات السياسية، ففي (حريق الكويت) نفهم أن الكويت هُنا هي منطقة (الجيلانية) التي وصفها الناس بأنَّها مثل الكويت لثراء ومكانة أهلها، نجد أيضًا الحديث عن أزمة حرب الخليج وظلالها الاقتصادية والاجتماعية، وهجرة بعض الفنانين لليمن ثم عودتهم إليها مثلما حدث مع “أمعيدة” بطلة فرقة “بنات أمريمي”، لكن الأهم من هذا تأثير ما هو سلطوي بشكل رمزي، تمثَّل في رفض زواج الإنسان مِمَّن يُحبُّه، وجاء هذا في فصل حمل عنوان (هي زوجتك أنت)، وفصل آخر بعنوان (كيف تزوج أبي أمِّي)، هذا الفصل الذي بيَّن أن الحقوق لا يمكن الحصول عليها سوى بالقوة أحيانًا.
ظلال أنثروبولوجية في الرواية:
الناظر لرواية (معلامة) علوان مهدي الجيلاني على أنَّها رواية سيرة ذاتية فقط، نظرته قد تكون سطحية جدًّا، لأنَّ الرواية تتجاوز حدود السيرة الذاتية إلى هذا الحشد الأنثروبولوجي من عادات وتقاليد، وأساليب حياة وطبقات اجتماعية، وحتى أنواع المأكل والملابس ونباتات العطارة وطُرُق بناء البيوت في اليمن في الفترة التي تتحدث عنها الرواية. لتتحول الرواية – لكثرة ما احتوته من هذه المفردات والمعاني – إلى ما يُشبه المرجع لكل باحث في الأنثروبولوجيا في المجتمع اليمني، فنجد من المظاهر الاجتماعية: الأعراس بكل تفاصيلها: (عاد الموكب الراقص إلى البيت، وظل اللعب متواصلًا، جدَّتي أمّ الخير وأخواتها أخذن أبي إلى عريش البرود يُحَنِّيْنَهُ، عند الساعة العاشرة، حَمّسَ الزّقَارةُ مَرافِعَهُم وصِحِيفَهُم (الزُّلَف)، استعدادًا لطقوس الدُّبْعَة (الحلاقة)، وقف المزين على رأسه، وتسابقت أمُّه وخالاته ينقطن، جدَّتي وضعت على رأسه ريالًا فرانصيًا، ثم وزعت نقطها على الرُّيّسا والزّقَارة، وخصَّت بنات أمريمي بريال كامل، تشكلت الدائرة، ولوى الزقار عمر محبوب رقبته وهمهم بفمه، وبدأ يَزقُر رقصة الزير، ودوّم مزمار زايد فيما راحت «عيدة» تتكسر، ويوسف عَبَد يَزْحَفُ… وهكذا)، مرورًا بالفرق الفنية والشعر الشعبي وبعض الأماكن، وأنواع من الملابس المحلية، والأدوات المعيشية المختلفة، وطرق تجهيز الطعام: (كانت جدَّتي تنزل المَحَمّةَ عن المُرُكّب ساخنة فيها السمن مع الخلاصة «البقيطا»، وتفتُّ فيها قرص العيش الساخن، وتتركه حتى يتشرب العيشُ السمن، ثم تضيف إليه الرائب باردًا ثقيلًا، تصُبُّه من دبية نظيفة تعتني بها فوق ما تفعل سائر النساء. ورائحة العيش المفتوت بالخلاصة والسمن والرائب، كانت تصيبني بالجنون، وتظل هي هدفي دائمًا، مهما تعدَّدت أنواع الخُصار “الإيدام” حولها كالقوار أو السقيل أو الحوت المالح أو البيض)، وحتى حيوانات البيئة في تلك الفترة (المُهرة، الحمار، القشوي، الكلاب وتربيتها، الكُبَيش، الهاش.. إلخ). والاهتمام بالعلماء والمشايخ وتعظيمهم، كذلك الاهتمام بالسيرة الشعبية مثل (الزير سالم)، وبعض العادات الريفية مثل تصديق الأساطير والاستعانة بالمجاذيب أو الشيوخ في مواجهة بعض المشكلات حتى وإن كانت صحية. كل هذا يعكس مدى تعمُّق الرواية في الأبعاد الأنثروبولوجية للمجتمع اليمني في تلك الفترة.
بعض ملامح التشكيل الفني للرواية:
على المستوى الفني قامت الرواية على آلية “الفلاش باك”، وهي استعادة الأحداث من الذاكرة، وفيها يكون المؤلف هو الراوي لغالبية الأحداث، ويُحمد للكاتب تلك القدرة على تذكُّر أدق التفاصيل، ليخلق لنا مشهدًا مكتمل العناصر يسهل على القارئ تخيُّله ومعايشة أحداثه، نلمس هذا في أكثر من مكان في الرواية، ولعلَّ أبرزها معرفة السبب الحقيقي في موت جدِّه بعد مرور ست سنوات حين قال: (بعد سِتِّ سنوات من موت جدِّي، كُنَّا قد كبرنا قليلًا، وتبدَّلت في واقعنا أشياء كثيرة، كنت وأخي إبراهيم في مجران المزرعة، وكان الوقت قبل المغرب بحوالي نصف ساعة، حينما سمعنا مُدَكِّن الجيلانية الشهير، وجارنا في الزّاهِيب بلغيث هَفَن يصرخ مستنجدًا بنا: أنا تمَسّيت يا أولادي، غيروا بسرعة، الحنش قضى عليّ، جريت أنا وأخي إبراهيم، كان الحنش ضخمًا أسود اللون فيه حُمرة جوار فمه، كان من نوع «الضّرا»، وكان يختبئ بين نباتات الثمام، وقد انطوى على نفسه وأبرز رأسه، هاجمناه وقتلناه، ثم ساعدنا عمَّنا هَفَن على الركوب فوق دابته ورافقناه إلى بيته. ليلتها تمَّ إسعافه إلى «الحديدة»، وعند الكشف عليه، واكتشاف كمية السُّم ونوعها، قال الطبيب: سيشفى، لكنَّهُ بعد سَنَة قد يُصاب بشلل؛ لأنَّ طبيعة هذا السُّم هكذا. يومها فقط تذكَّرنا لماذا كان «مساوى» شيخ الزار، وهو يَسْتَحْمِل على جدِّي يقول: (هاَشُّو). لقد أصيب جدِّي في مكان يبعد عن مكان إصابة هفن بحوالي مئة متر، ومثلما أصيب جدِّي بالشلل بعد عام من قبصة الحنش له، كان هفن على موعد مع الشلل بعد عام من قبصة الحنش له، وقد ظلَّ مريضًا حتى مات).
توظيف لغة الحوار، مِمَّا يعكس ثقافة الكاتب وإلمامه بفن المسرحية باعتبار لغة الحوار هي اللغة التي يقوم عليها الفن المسرحي، وتوظيف الرواية للغة الحوار يعطي للرواية أبعادًا درامية وحيوية للمشهد الروائي من ناحية، كما يعطي للرواية الصدق الفني من خلال توظيف اللهجة العامية في هذا الحوار ليقتنع القارئ بطبيعة الشخصية الروائية. مع تطعيم الحوار في أوقات كثيرة بأبيات من الشعر الشعبي للمزيد من هذا الإقناع، وللمزيد من هذا التأثير في القارئ، ولتوضيح مدى سعة ثقافة الكاتب وحبه للفن والأدب.
ومع دقة الكاتب في رسم الشخصية الروائية نجد أيضًا الدقة في وصف المكان بكل تفاصيله، بما يعكس سعة الخيال عند الكاتب، فها هو يصف الطريق الواقع على حدود غابة الدومة بقوله: (على حدود غابة الدُّوم من الجهة الغربية طريق الزيدية، الطريق الترابي الذي تعبر منه السيارات والشاحنات القادمة من الحديدة وتعز والزيدية والضحي وبيت الفقيه وزبيد وصنعاء، أو القادمة من السعودية وحجة وصعدة وعبس ووادي مور والقناوص وبلاد المهادلة، كما يسلكه الحمّارة (المواعدة) القادمون من جهات المنيرة والزيدية، وخبت صليل الجنوبي وبلاد الحشابرة، وتمُرُّ به صباح كُلَّ خميس قطارات الجِمال المُحمَّلة بصناديق خشبية مليئة بالبسكويت الضحوي، نقف نتفرَّج على قطاراتها الطويلة بإعجاب، فيما يرمي لنا جمّالتها حبَّات البسكويت. تمُرُّ السيارات والشاحنات ببتراتها المُخرَّقة، ومعاونيها الراكبين على البنكات؛ استعدادًا للنزول في أيَّة لحظة تغرز فيها السيارة أو الشاحنة في الرمل، كُنَّا نرى وظيفة المعاون الراكب على البنكة متعة تفوق كُلَّ متعة، أمَّا أنا فكانت متعتي حين تمُرُّ سيارة أو شاحنة، وصوت المطرب يصدح فيها).
وعلى مستوى البناء الهندسي للرواية، جاءت الرواية من الحجم المتوسط، مُقسَّمة إلى عدة فصول، كل فصل أشبه باللوحة الفنية مكتملة التفاصيل، ورغم هذا تُقرأ الرواية دفعة واحدة متتابعة، بسبب عنصر التشويق الذي اعتمد عليه الكاتب في رسم الحدث الروائي، ورُبَّما جاء بناؤها على هذا النحو ليكون تقسيم الرواية إلى هذا العدد من الفصول بمثابة إشارة رمزية ضِمْنية لتفكُّك العالم – بلغة جاك ديريدا – ليكون شكل الرواية رمزًا لهذا التفكُّك، ويكون متنها المتمثل في وحدة نسيج أفراد العائلة رمزًا للدعوة للتخلص من هذا التفكُّك والاقتتال المجتمعي الداخلي.
*شاعر وكاتب مصري












تعليقات