عبدالوهاب الحراسي*
قصيدة كتبها الشاعر اليمني عادل عبدالإله العصار، كانت قد ضاعت لديّ، منذ أكثر من عقد، ولطالما طلب استعادتها. وظننت أنني لم أجدها، بينما كنت قد وجدتها ورفعتها له كي أفرحه، ولكني نسيت هذا أيضًا، وشاء القدر الساخر أن أراها قبل وفاته بأيام، ولم أنتبه لها، ولا لمن هي ! يا الله ! هذا لم يعد نسيانًا، هذا فجور النسيان.
هكذا شاء الله ألا يستردها الشاعر في حياته؛ وها أنا أرد الأمانة إلى أهلها مع طلب الصفح منهم. تم إرسال المخطوط لزوجة الشاعر مع زوجتي وسلمتها لها يدًا بيد.
إنها قصيدة تستحق البقاء.. إنها “زبور الكلام”
زبور الكلام
قبل أن يولد الحرف.
كان الكلام صدىً
والحكايات تشكو بداياتُها الانتهاء..
كان الكلام سرابًا على شفة الريح
سرعان ما يتلاشى
***
وكل الذي كان
أسطورة لم تدونها صفحات الجهات
***
كانت اللحظات حياةً
والناس كاللحظات
أسعدها ليس يبقى
وأجملها لم تخلده الكلمات..
***
ليت معجزة الأبجديات
تقرأ ذاكرة الريح
ترسم أنفاسها أسطرًا وحكايات
***
ليت أصداء ما كان
تأوي محمّلة بالأساطير
ليتها بالذي كان تأتي
ونحصد مواسمها الضائعات
***
ليت نهر المدى
يرتوي بالخيال الطفولي!!
هل تراه سيزهر؟؟
سيزهر يومًا…
ويعلن ميلاد أمس الحياة.
صنعاء – 2010/9/5
قصيدة من النوع الذي يقرأ عدة مرات، هو نص شعري عذب، ناعم وحنون، ذلك ما يجعل القارئ يستمرئ إعادة قراءة القصيدة مرتان وثلاث وأربع بغية كسر شفرة رسالتها، والاطمئنان إلى حصول فكرة محيطة تحُدّ من انفلات المعنى من القارئ، ولا يضيق من مراوغته، فكم من قصيدة عظيمة سقطت بسبب صعوبة شفرتها وأشاح المتلقي وجه أدبه عنها بسبب مبناها وترصيع الفاظها؟!
الحسرة على مفقود، والشوق لضائع نفيس، والإحباط المسكون بالأمل.. ذلكم هو ما فرض على النص إيقاعه الحزين.
السطور الشعرية، في معظمها، وتموقع الدلالات لا تنتج تعبيرًا ولا صورًا شعرية، بقدر ما هي أفعال وكائنات معنية بذاتها، ولها دور وقيمة في فكرة النص.. إنها، بحق، تنفلت من الاستعارات. الاستعارات التي تجعل من الخطاب شعرًا أو شاعريًا. لكن إذا كان الأمر هكذا (أي هذا النص الشعري يتحدى الاستعارات) فما الذي يجعل من هذا النص شعرًا؟
إن ما يجعله كذلك، هو الحديث السردي (من خلال صور إبداعية مبتكرة ودلالات تعبيرية نوعية) عن شعور عميق بسلام وجمال عالم قديم مبهم ينتمي أو يختص بفترة معينة من طفولة البشرية.
هذا العالم الغامض الذي تبحث عنه روح الشاعر وتتشوقه، هو الذي جعل من صياغة الأفعال والكلمات: يولد، صدى، الكلام، سرابًا، شفة الريح وذاكرة الريح، نهر المدى، الأساطير… دلالات تدل بذاتها وليست استعارات، لكنه في ذات الوقت يعيد للاستعارة مكانتها ودورها الشاعري حين ننظر إلى مجمل النص.. إذْ كيف يمكن الحديث عن شيء/ عالم غامض ومفقود ضاع منذ عشرات آلاف السنين، ولا أحد يعرفه اليوم، ولا يمكن لأحد أن يتذكره أو يتخيله إلا بالاستعارة.
إن هذا التناوب للدلّ بذاته والاستعارة هو ما يجعل هذا النص الشعري زبور الكلام !! حتى إن من دلالات كلمة “الزَّبُور: أنه كُلّ كِتَاب يَصْعُب الوُقُوفُ عَلَيْهِ من الكُتُب الإلهيَّة”.
التلاشي والخلود
لكن هل يمكننا أن نجلي، من النص، هذا العالم الغامض ونكشف عن ملامحه؟ نستطيع، فقط، الاقتراب منه وتلمسه من خلال تجنيس أو تصنيف الدلالات إلى صنفين:
– دلالات تواصلية: الشفة، الريح، الكلام، الصدى ومدلولاتها: الصوت والتواصل والانتقال ثم الضياع والتلاشي والانتهاء. وثمة دلالة جمعت الأبستمولوجية والتواصلية هي “الحكايات”، إذ هي حاملة لمعرفة، لكنها قبل ذلك شفاهية التنقل، ولا تملك القدرة على البقاء.
يقف الشاعر على مستحثات، على أنقاض مجهرية، على مشاهد النزع الأخير، على التلاشي والانتهاء:
” كان الكلام صدىً
والحكايات تشكو بداياتُها الانتهاء..”
وتأتي قمة الإبداع وذروة الخيال عن خِفّة التلاشي:
“.. كان الكلام سرابًا على شفة الريح سرعان ما يتلاشى”
– دلالات أبستمولوجية: زبور، الحرف، أسطورة، الأبجديات، تقرأ، ذاكرة، أسطر، الخيال.
والحرف والأبجديات وأسطر مدلولات للثبات والحفْر والبدايات والبقاء. إنها للتخليد، لكنها ليست الخلود! إن العصار على يقين منطقي باستحالة الخلود، لكنه يتحسر عليه:
“كانت اللحظات حياةً
والناس كاللحظات
أسعدها ليس يبقى
وأجملها لم تخلده الكلمات..”
لكن، أيضًا، تأتي الدلالات: تقرأ، ذاكرة، الخيال، الأبجديات، ومدلولاتها: عمليات التعلم، وإمكانات المعرفة، والقدرة على التفسير والخلق، والتي يقر الشاعر باعتماده عليها في تحقيق شوقه الروحي.
بهذه الدلالات ومدلولاتها نصبح على عتبة رؤية هذا النص/ القصيدة.
الرؤية
يتأسس خلق هذا النص على قانون فيزيائي متعلق بكينونة المادة؛ وهو قانون ذو شقين، والشق الأول، تحديدًا هو المعني بتأسيس رؤية الشاعر في النص، على أن هذه الرؤية ليست حكرًا انفرد بها الشاعر، بل الرؤية معروفة ومتداولة في كتب وأبحاث علوم الفيزياء مفادها: أنه ما دام وأن كل ظواهر الطبيعة هو مادة (لها أبعاد ويمكن قياسها)، وبما أن الصوت هو مادة (موجات وترددات واهتزازات) وأنه ما دامت المادة باقية، فإن أصداء (آثار) التعاليم والتصريحات المأثورة (الأصوات، الكلام) وأصوات الطيور والديناصورات لم تتلاشى، بل ما زالت موجودة وباقية تسبح في الأثير وتمتطي الريح:
“كان الكلام صدىً
والحكايات تشكو بداياتُها الانتهاء..
كان الكلام سرابًا على شفة الريح
سرعان ما يتلاشى
وكل الذي كان
أسطورة لم تدونها صفحات الجهات”
يتلاشى الكلام (الصوت) وتتلاشى الصور الراوية للأحداث كما تنقضي وتأفل اللحظات الغنية والحافلة بالسعادة والجمال، والتي تستحق التخليد، لكن أصداء/ آثار كل ذلك ما زال موجودًا وباقيًا، لكن تلك الآثار ضائعة منا خافية علينا.
وهنا تأتي “معجزة الأبجديات” التي تمناها الشاعر، رمزًا للعلم الذي سيحقق، يومًا ما، معجزته، فيلتقط ويجمع ويحدد ويصنف تلك الأصداء (الموجات الصوتية):
“ليت معجزة الأبجديات
تقرأ ذاكرة الريح
ترسم أنفاسها أسطرًا وحكايات
ليت أصداء ما كان
تأوي محمّلة بالأساطير
ليتها بالذي كان تأتي
ونحصد مواسمها الضائعات”
يتشوق الشاعر أن ينتهي العلم بأن يعرض لنا سيلاً، يملأ المدى، بالخيال الطفولي، ومدى الشاعر ليس مدى النظر أو السمع، بل مدى الحياة.. ثم يتساءل هل سينجح العلم بتحقيق ذلك:
“ليت نهر المدى
يرتوي بالخيال الطفولي !!
هل تراه سيزهر؟؟”
وسريعًا يكون إيمان الشاعر بجواب قطعي بالإثبات، وبأننا سنشهد أزمان الماضي حاضرة تعيش معنا في زمننا الذي سيكون:
“سيزهر يومًا…
ويعلن ميلاد أمس الحياة..”
“ميلاد أمس الحياة” ما هو إلا حال عالم ظواهره لم تدركها الحواس، وألوانه لم ترها العين، وأصواته لم تسمعه الأذن. حال عاشتها وستعيشها الإنسانية في مرحلة معينة من التطور العلمي سيجعل حياة البشر زاخرة بالخيال والإبداع والمتعة، حياة فيها واقع الناس كان وسيكون مزيجًا من خيال الميتافيزيقا وحقائق الفيزيقا. حياة أسطورية حيث الأمان والراحة والنبالة والخلود.
تتمة مبتذلة
لا شك أن عادل العصار كان مطلعًا على نصوص الأساطير، بل كان مولعًا بالأساطير الكبرى لبلاد الرافدين التي تمجد القيم النبيلة وتفسر الوجود والخلق والحياة والمعرفة ومحاولات الخلود، لكنه كان يعي أنها مجرد نصوص لا عقلانية ومستحيلة، وبالرغم من ذلك نراه يطلبها ويتمناها حتى أبدع هذا النص!! لماذا فعل هذا؟ ثمة سببان:
الأول: أنه لم يكن ينتمي إلى نسق فكري ونظام سلطوي (أيديولوجي أو ديني) ينهي نظرته للأساطير.
والثاني: هو ارتباك الشاعر وحيرته وشعوره بالرعب مما يشهده في عالمه: حروب وقسوة ومجاعات وحصار وظلم، موت وألم واستغلال للبشر، وقلقه العميق، من المستقبل.. المستقبل الذي، بدأ اليوم، في تقويض مفهوم الإنسانية، ويحل محله عدم اليقين، وطغيان حقوق وأسعار الآلة والآلية؛ وهو يرفض أن تكون النهاية هو هذا الوجه من المستقبل.
عادل العصار شاعر وصحافي، عمل لعقود في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر اليمنية، وكان سكرتيرًا لتحرير مجلة معين، توفي في 25/ 8/ 2025 م.
أديب وكاتب يمني
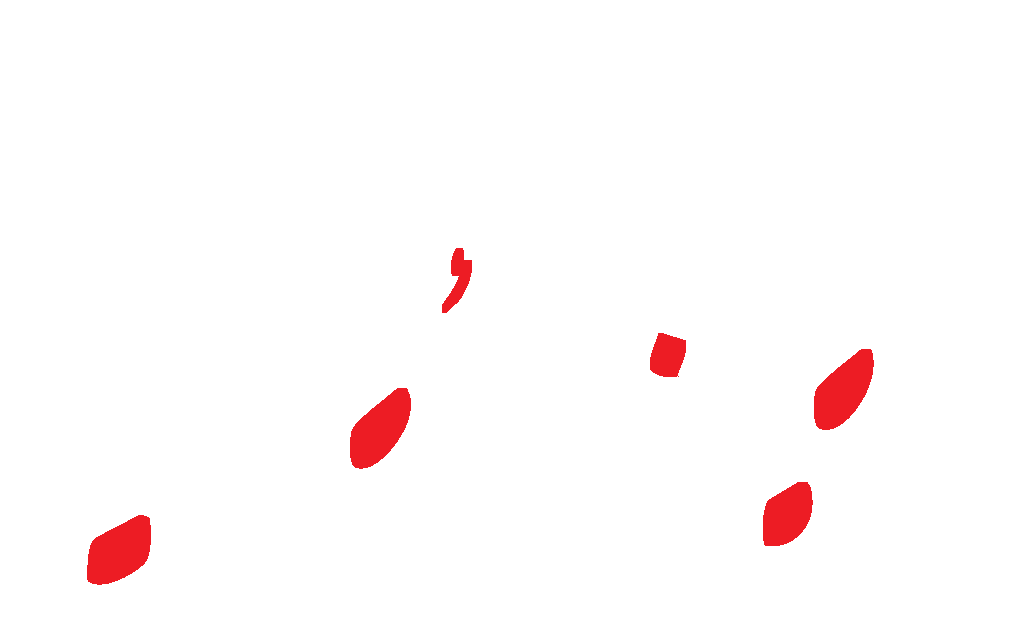

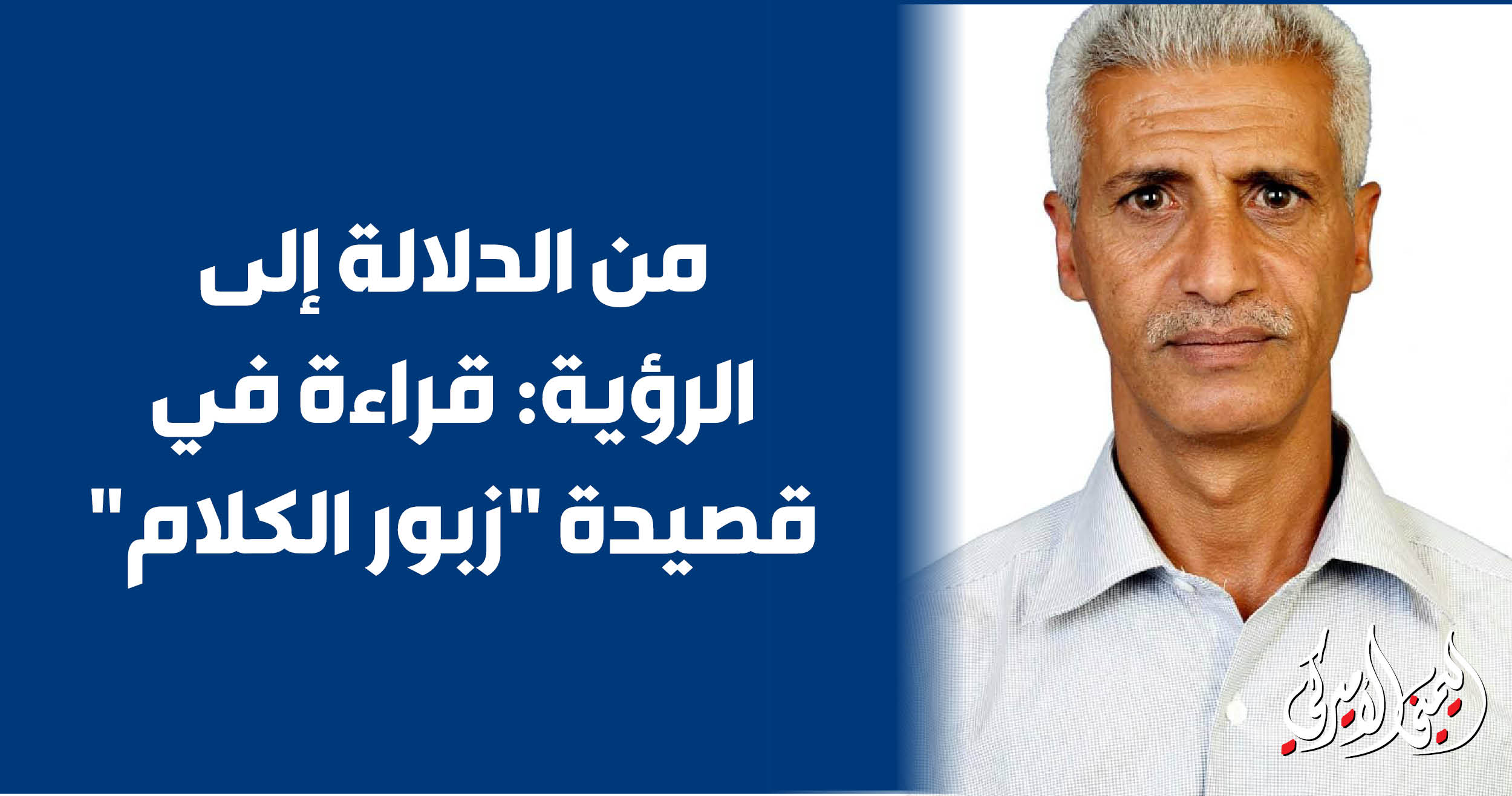




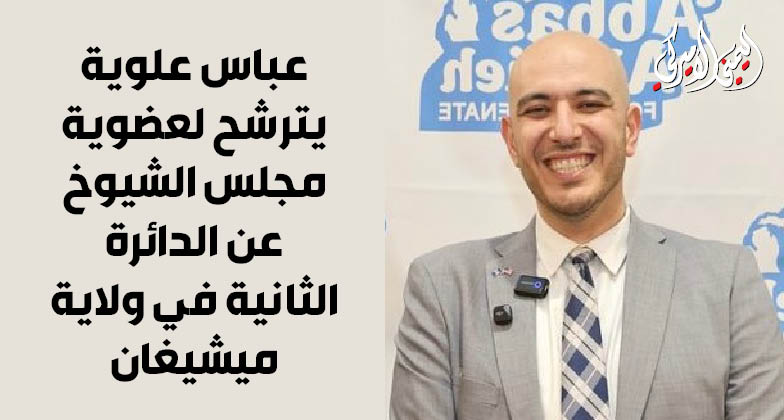

تعليقات