بقلم/ محمد رزق
قد يبدو حدثٌ ما بسيطًا للوهلة الأولى، لكنه يكشف في جوهره عن حقيقة أعمق تتعلق بالفارق بين الأمم التي تُبنى على المؤسسات والرؤية، وتلك التي تحرّكها العواطف ومنصّات التواصل الاجتماعي.
فعندما فاز العالم الأميركي عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025 بالمشاركة مع زميلين آخرين، احتفى العالم العلمي بإنجازٍ يوسّع حدود المعرفة البشرية. غير أنّ النقاش في العالم العربي انحرف سريعًا من إنجازه العلمي إلى جنسيته وأصوله.
ياغي من أصلٍ فلسطيني، وُلد في الأردن، ونال الجنسية السعودية عام 2021. وبدلًا من الاحتفاء بقيمة اكتشافه العلمية وبأثره الإنساني، انشغل كثيرون بتنازع نسبه إلى أوطانهم، كلٌّ يريد أن يضمّه إلى تاريخه الوطني.
تلك اللحظة تختصر مأزقًا حضاريًا؛ فبينما ينشغل الآخرون بتمويل المختبرات وبناء أنظمة البحث العلمي التي تُنتج أعمالًا تستحق نوبل، ما زال مواطنو بعض الدول في العالم العربي يتنازعون على هوية عمر ياغي وجنسيته.
إنّ الفخر الوطني الحقيقي لا يتجسّد في جنسية العالم أو في نسبه بعد نيله الجائزة، بل في تهيئة الظروف التي تُمكّن العالم التالي – والأجيال القادمة – من الإبداع والتميّز، وصنع الفارق في هذا العالم.
قصة من نوعٍ آخر
على النقيض من ذلك، قدّمت قصة نوبل أخرى لمحة عن ثقافة مختلفة تمامًا. فعندما أُعلن عن جائزة نوبل في الطب مطلع أكتوبرالجاري، عجزت لجنة نوبل عن التواصل مع أحد الفائزين وهو العالم الأميركي فريد رامسديل.
رامسديل، الذي كرّم مع ماري إي. برونكو وشمعون ساكاغوتشي لبحوثهم الرائدة في الخلايا التائية التنظيمية والتحمّل المناعي، كان في رحلة مشي طويلة في غرب الولايات المتحدة، بعيدًا عن الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول. ووفقًا لشركته سونوما بيوثيرابيوتكس، كان ”يعيش أفضل أيامه“، منغمسًا في الطبيعة، بعيدًا عن صخب العالم.
استغرق الأمر قرابة عشرين ساعة قبل أن يكتشف أنه حصل على أرفع الجوائز العلمية في العالم.
وتعيد هذه القصة إلى الأذهان حادثة مشابهة: ففي صباحٍ هادئ بولاية بنسلفانيا عام 2023، خرج الدكتور درو وايزمان في نزهة دون هاتفه، غير مدركٍ أنّ لجنة نوبل في ستوكهولم كانت تحاول الوصول إليه بلا جدوى.
وبينما كان يستمتع بنسيم الخريف، كانت اللجنة تعلن فوزه، بالاشتراك مع زميلته كاتالين كاريكو، بجائزة نوبل في الطب عن عملهما الرائد في تطوير تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) – التقنية التي شكّلت أساس لقاحات “كوفيد-19” وأنقذت ملايين الأرواح حول العالم.
وحين عاد وايزمان إلى منزله بعد ساعات، وجد بريده الإلكتروني ورسائله غارقة بالتهاني، فابتسم وقال ببساطة: ”خرجت لأستنشق بعض الهواء النقي، وعدتُ لأجد أن حياتي قد تغيّرت“.
يا لها من صورة مدهشة: عالم غارق في بساطة الحياة، لا يعلم حتى إنه صنع التاريخ. إنها صورة لمجتمعٍ مؤسّساتي قوي، يُقدّر البحث العلمي بهدوء وثبات، دون ضجيج ولا استعراض. في مثل هذه البيئات، لا يسعى العلماء إلى الأضواء، بل إلى الإجابات والحلول.
الفجوة العلمية العالمية
تبرز قصص رامسديل ووايزمان وياغي جوهر الفارق بين الاستثمار العلمي المستدام والاحتفاء الرمزي العابر، وهي تفسّر لماذا لا تمتلك إلا قلّة من الدول نصيبًا وافرًا من الاكتشافات الكبرى. تشير الإحصائيات إلى أنه حتى أكتوبر الجاري، تظل هناك ثلاث دول حول العالم تحصد الجوائز الأكثر منذ بداية تأسيس جائزة نوبل ومنحها لأول مرة عام 1901، حيث حصلت الولايات المتحدة الأميركية على 428 جائزة ويمثل هذا الرقم حوالي 34% من إجمالي جوائز نوبل الممنوحة عالميًا، تليها المملكة المتحدة بـ 145 جائزة، ثم ألمانيا بـ 116 جائزة. وهذه الجوائز لم تُمنح من فراغ، بل جاءت نتاج إيلاء البحث العلمي الأهمية التي يستحقها، والاستثمار فيه بقدْر ما توليه هذه الدول للعلم من أهمية تليق به.
فبحسب المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) في الولايات المتحدة، بلغت نفقات البحث والتطوير الأميركية نحو 892 مليار دولار عام 2022، وقرابة 940 مليارًا عام 2023.
هذا التمويل الضخم يغذّي منظومة متكاملة من الجامعات والمختبرات والصناعات، تُشكّل بدورها محرّك الابتكار في التكنولوجيا والرعاية الصحية واستكشاف الفضاء.
في المقابل، يبقى الاستثمار العربي متواضعًا. على سبيل المثال أنفقت المملكة العربية السعودية – أكبر اقتصاد عربي – نحو 6 مليارات دولار على البحث العلمي في عام 2023، وهي زيادة واعدة لكنها لا تزال تمثل جزءًا بسيطًا من إنفاق الدول الرائدة. أما الأردن، فيتراوح إنفاقه السنوي على الأبحاث بين 200 و450 مليون دولار فقط.
هذه الفجوات ليست أرقامًا عادية؛ إنها الفارق بين الاقتصادات المنتِجة للمعرفة وتلك المستهلكة لها. فالبحث العلمي هو أساس القوة الوطنية، ومصدر الصناعات المتقدمة والنفوذ العالمي. إنه ما يحوّل الموهبة إلى تكنولوجيا، والفكرة إلى صناعة.
تُظهر التجارب أن الدول التي تخصّص ما بين 1 و2% من ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، تحقق قفزات نوعية في الابتكار والتعليم وبراءات الاختراع. فالعلم مشروعٌ تراكمي، كل جيلٍ من العلماء يبني على إرث من سبقه.
وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية التي تولي البحث العلمي أهمية كبرى، حيث تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وهو ما سيمثل تحوّلًا استراتيجيًا نحو ترسيخ مكانة المملكة بين اقتصادات المعرفة الرائدة عالميًا.
من الاحتفال إلى الإبداع
القصتان – الجدل العربي حول عمر ياغي، ونزهة وايزمان الصباحية – تكشفان جوهر التحدي أمام العالم العربي اليوم.
في عالمٍ، يُعدّ العلم مشروعًا وطنيًا، مدعومًا بسياسات وميزانيات ومؤسسات راسخة. وفي عالمٍ آخر، لا يزال إنجازًا رمزيًا يُحتفى به بعد وقوعه، دون أن يُمكَّن قبل حدوثه.
إذا أراد العالم العربي أن يكرّم علماؤه بحق، فعليه أن ينتقل من نَسبهم إلى دعْمهم، من الاحتفاء بهم بعد النجاح إلى تمكينهم قبل الإنجاز.
إنّ الأمم التي تستثمر في المعرفة لا تحتاج إلى المطالبة بنَسَب علمائها، فالعلماء الحقيقيون هم من يفاخرون بالانتماء إلى أوطانٍ منحتهم أدوات الفكر، واحتضنت طموحهم، ووفّرت لهم بيئة تُقدّر البحث والاكتشاف. فحيثما تُكرَّم العقول، تزدهر الأوطان، ويغدو العالِمُ هو السفير الأصدق لقيمة أمّته ومكانتها بين الأمم.
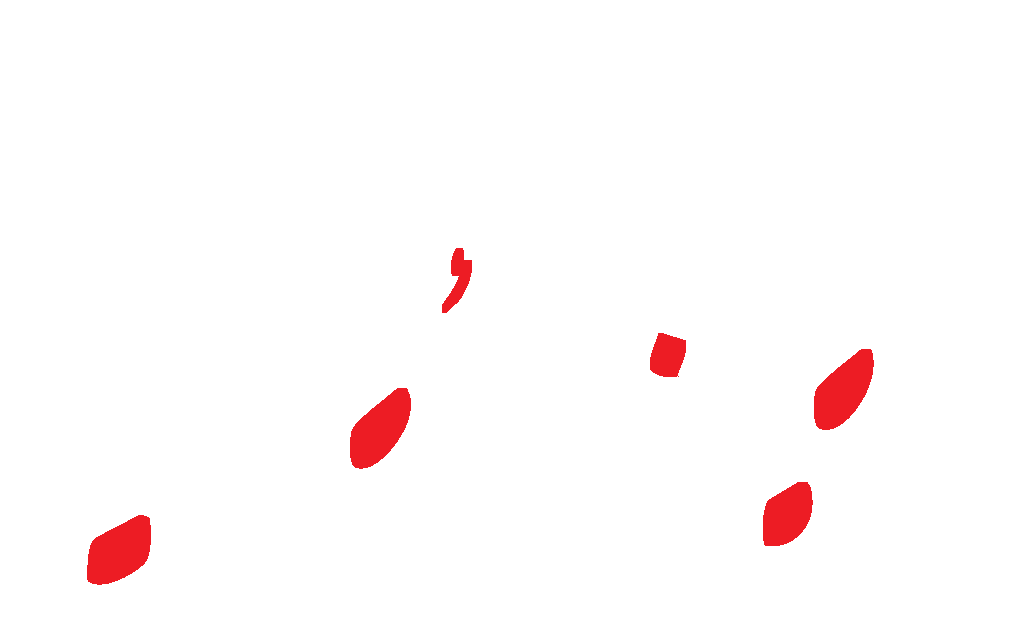


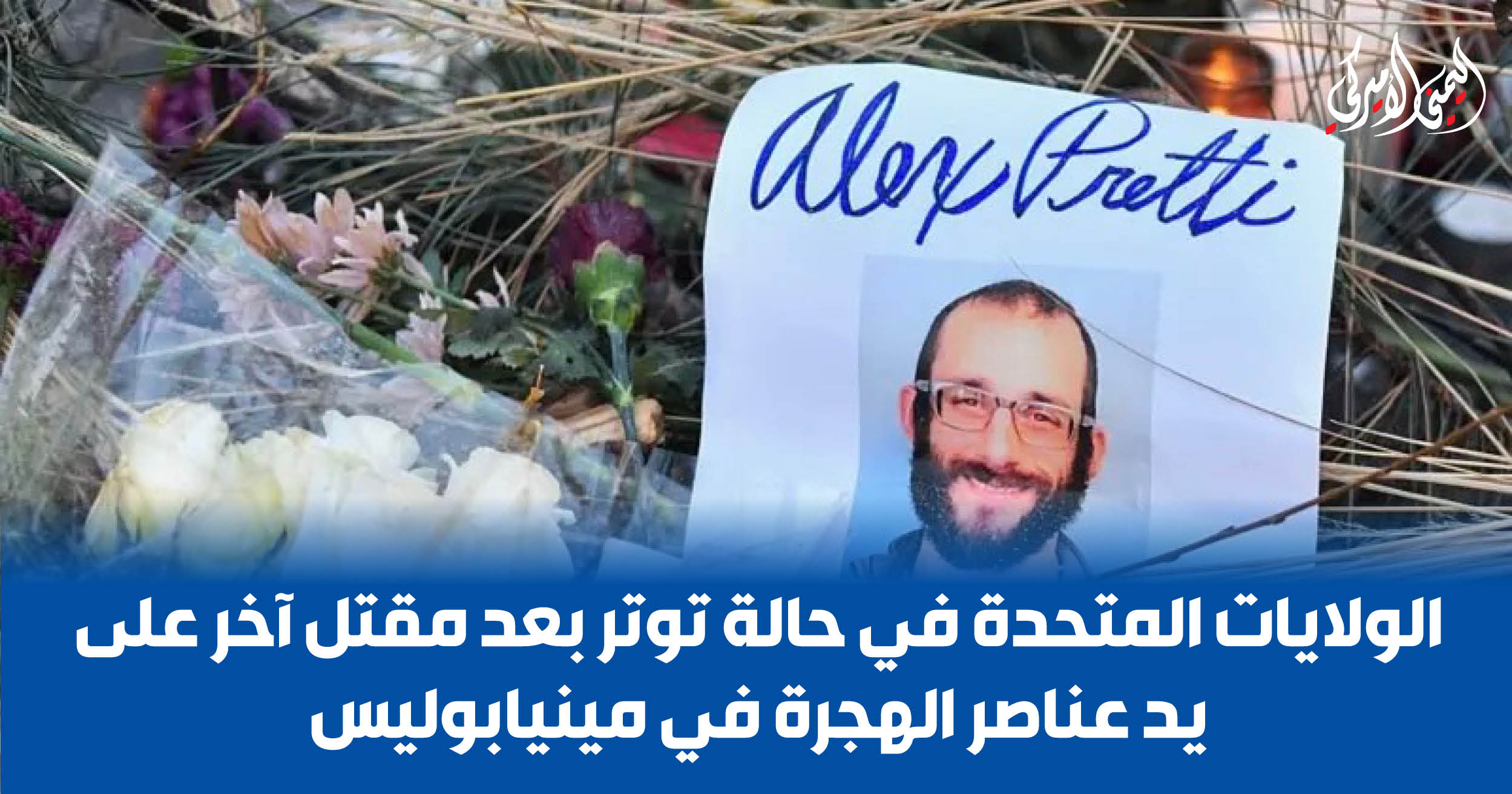



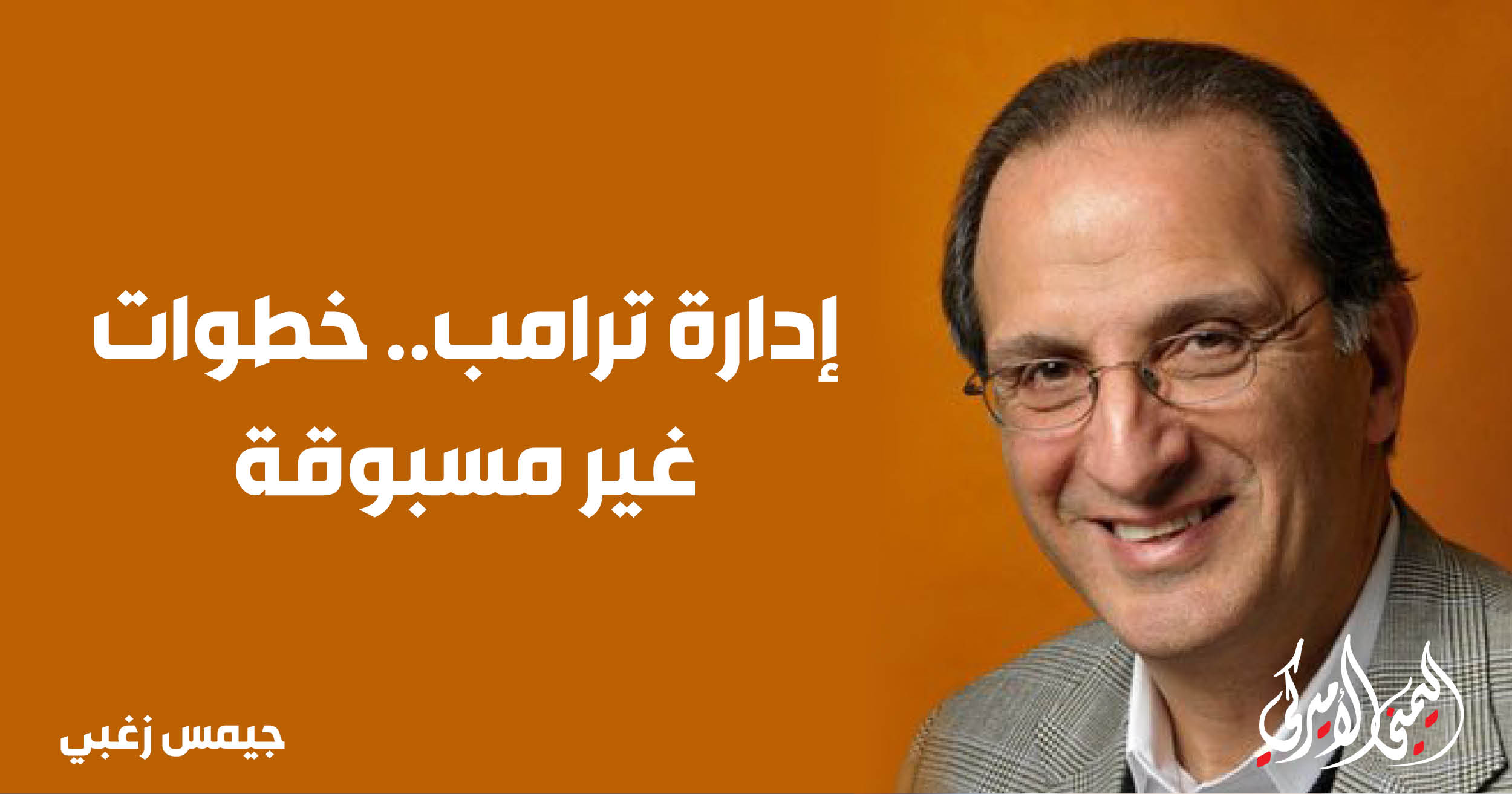

تعليقات