وجدي الأهدل*
النقد الأدبي والفني الذي يقوم على (المقارنة) خاطئ ومضلل. إذا افترضنا أن ناقدًا إنجليزيًا مرموقًا سافر إلى أثيوبيا، واطلع على الأدب والفن الأثيوبي، ثم ألقى محاضرة على النخبة المثقفة في جامعة أديس أبابا، وتكلم باستعلاء وحطّ من قيمة الآداب والفنون المحلية، وراح يطالبهم بأن يكتبوا على غرار (تشارلز ديكنز) و(ت. س. إليوت) و(جورج برنارد شو) وأن يرسموا مثل (ديفيد هوكني)، فإن هذا الرجل لا يستحق لقب (ناقد) وإنما يستحق أن يوصم بأنه (مهرج).
إن تطور الآداب والفنون في أثيوبيا أو أية دولة أخرى، له علاقة بموقعها الجغرافي، وبتاريخها السياسي، وبالحياة الاجتماعية التي تشمل الدين والأخلاق والأعراق والتعليم، وكل ما يشكل في النهاية الشخصية الخاصة للإنسان العائش في تلك الرقعة المحددة من العالم.
وبالتالي من السخف أن نحاول (المقارنة) بين أدب شعبين تفصلهما آلاف الكيلومترات، وتختلف ظروفهما التاريخية والاجتماعية والاقتصادية اختلافًا جذريًا.
الناقد الحاذق هو الذي يستفيد من المناهج النقدية الحديثة ليدرس الأدب المحلي، والناقد المتحذلق هو الذي يتخذ من الآداب الأجنبية نموذجًا، ثم يطالب أدباء بلاده بالنسج على منوالها، واستنساخ طرقها وأساليبها.. وبالطبع هناك أعمال أدبية عالمية خالدة، وحتمًا أن الكاتب الناشئ ينبهر بها -وهذا أمر مطلوب في البدايات- ولكن مهمة الناقد صاحب الرؤية الصحيحة هي أن يُوجه بوصلة الموهوبين نحو تطوير أدبهم المحلي، بأدوات مأخوذة من داخله، وليست مستعارة من خارجه، وأن يطوروا نسقًا خاصًا من الخيال الإبداعي يستمد جذوره من الحكايات الشعبية، والخرافات التي تسكن وجدان الشعب، ومن كل ما ليس مطروحًا من قبلُ في كتاب، ويمس بصورة مباشرة الحياة اليومية لأصحاب الأرض.
يفهم الناقد المغرور بثقافته الواسعة الآداب الأجنبية جيدًا، لأنها مشروحة شرحًا وافيًا، ولكنه حين يواجه الأدب المحلي المكتوب في بلاده وجهًا لوجه، فإنه يبذل كل طاقته الفكرية الزائفة لقولبته في قوالب مستقاة من آداب قارات أخرى، وهكذا يُريح نفسه من عناء الدراسة الجادة، ويكتفي بقول القشور التي وعاها من قراءاته النظرية.
وهذا الناقد السطحي الذي يتسلح بكثير من المصطلحات النقدية العويصة، يتبرم، وينزعج، ويقلق، إذا ما عجز عن تنميط الأدب المحلي في تيارات أو مدارس أدبية أوروبية، ولكي يُخفي ارتباكه يُصدر فتوى نقدية بأن الأدب المحلي ليس راقيًا بما فيه الكفاية!
هذا النوع من النقاد ينسى أن النص الأدبي في الغرب هو الذي سبق أولاً، ثم تلاه الشرح النقدي.. وأن العملية التفاعلية بين الأدب والنقد تحدث بهذا الترتيب وليس العكس.
وخلاصة الأمر أن على الناقد الجاد التخلي عن كل معرفته السابقة، وأن يستخلص المعرفة من النص الذي يدرسه، أن يستنتج القواعد من نخاع الإبداع ذاته، وأن يتوصل إلى ما هو كامن خلف السطور.. بصفته ليس ناقدًا فحسب، ولكن لكونه مواطنًا يُفترض به أن يكون على دراية تامة بالتفاصيل الدقيقة للحياة البشرية في بلاده.
قال الحكيم الهندي أوشو: “المقارنة تخلق الدونية والتفوق، الأهلية وعدم الأهلية. حين لا تُقارن تختفي كل دونية وكل تفوق. عندئذ توجد أنت، وتكون أنت هناك، شجيرة صغيرة أو شجرة باسقة، لا يهم، إنك أنت نفسك”.
الأدب اليمني اليوم هو بالكاد شجيرة صغيرة، تقاوم بكل قوتها الرياح العاتية التي تحاول اقتلاعها.. لا شيء يسند هذه الشجيرة، لا أحد يحاول حمايتها، إنما هي بجهودها الذاتية تكافح للبقاء والاستمرار في الحياة.
على مر مئات السنين عمل الأدباء اليمنيون في بيئة شحيحة وعدائية أحيانًا، والحال الغالب هو تجاهلهم وتهميشهم وإفقارهم عن طريق استبعادهم من مراكز النفوذ والسلطة، واستمر هذا الوضع حتى وقتنا الحاضر.. فلذلك لم يحدث التراكم الأدبي الذي يمنح كل جيل جديد إرثًا ثقافيًا يبني عليه ويستمد منه وقودًا لتجويد الإبداع وتطويره.
يجب على الناقد اليمني أن يكون مطلعًا على التاريخ الثقافي لبلاده، وأن يقرأ تاريخها السياسي، لأنه حينئذٍ سيدرك لماذا لم تكن صنعاء وعدن وتعز حواضن ثقافية على غرار القاهرة ودمشق وبغداد، وما هو دور المحيط القبلي في البناء والهدم، وكيف تؤثر الاضطرابات السياسية المتكررة على شجيرة الأدب والثقافة وتحد من نموها.
ها نحن نرى عيانًا كيف شتتت الحرب المثقفين والأدباء اليمنيين في أصقاع الأرض، وأغلقت صحفهم ومجلاتهم، وأوقفت وجمدّت مؤسساتهم مثل اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وقزّمتهم وأسكتت أصواتهم، فلا صوت يسمع إلا صوت السياسي أو المثقف المسيس.
الثقافة الشعبية في اليمن تبجل من يحمل السلاح، وتزدري من يحمل القلم.. والكلمة العليا هي لمن يحمل السلاح حتى يومنا هذا، وأما حملة الأقلام فليس لهم حول ولا قوة.
والشاهد أن الناقد اليمني لا يليق به أن يلعب دور المستشرق؛ الذي ينظر من علٍ إلى ثقافة أدنى منه، بل عليه أن يساهم بشكل فعال في رعاية الشجيرة الصغيرة ومدّها بأسباب البقاء والحياة.
ينتمي النقد الأدبي والفني إلى هذه الشجرة الصغيرة نفسها، فهو فرع من فروعها، قوته من قوتها، ومنها يستمد نسغ الحياة.. فالأدب والنقد كيان عضوي واحد.
قد يتمكن النقد الجيد من إسماع أصوات الأدب ضمن دوائر أوسع، ولعل الدور الوظيفي للنقاد هو تمكين المؤثرات الأدبية والثقافية من الوصول إلى المجتمع.
*روائي وكاتب يمني.
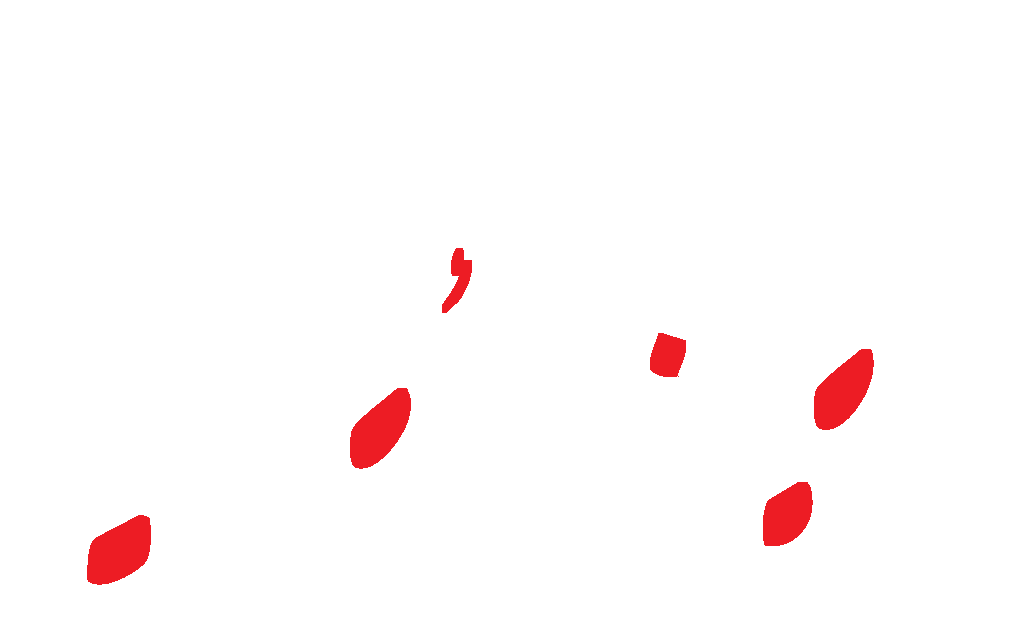






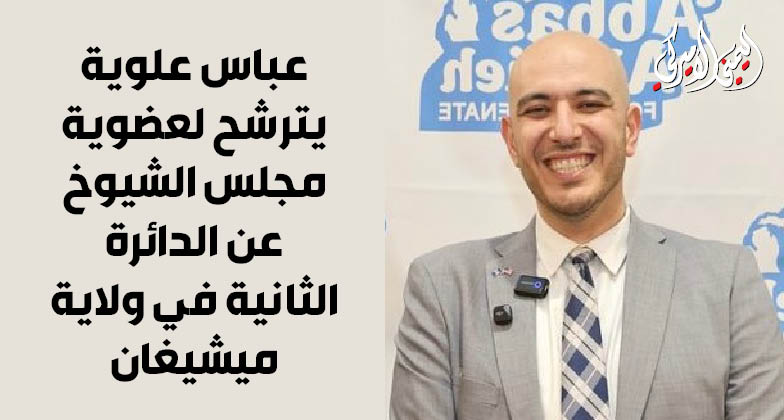

تعليقات